للشيخ/ يوسف القرضاوي
إن بيان هذا التطرف وتحديد المراد به بعلم وبصيرة، هي الخطوة الأولى في طريق العلاج منه.
التعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر:
1- إن أولى دلائل التطرف : هي التعصب للرأي تعصباً لا يعترف معه للآخرين بوجود، وجمود الشخص على فهمه جموداً لا يسمح له برؤية واضحة لمصالح الخلق، ولا مقاصد الشرع، ولا ظروف العصر، ولا يفتح نافذة للحوار مع الآخرين، وموازنة ما عنده بما عندهم.
ونحن هنا ننكر على صاحب هذا الاتجاه ما أنكرناه على خصومه ومتهميه، وهو محاولة الحجر على آراء المخالفين وإلغائها.
أجل، إنما ننكر عليه حقاً، إذا أنكر الآراء المخالفة ووجهات النظر الأخرى، وزعم أنه وحده على الحق، ومن عداه على الضلال، واتهم من خالفه في الرأي بالجهل واتباع الهوى، ومن خالفه في السلوك بالفسوق والعصيان، كأنه جعل من نفسه نبياً معصوماً، ومن قوله وحياً يوحى! مع أن سلف الأمة وخلفها قد أجمعوا على أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويُـترك، إلاّ النبي صلى الله عليه وسلم .
والعجيب أن من هؤلاء من يجيز لنفسه أن يجتهد في أعوص المسائل، وأغمض القضايا، ويفتي فيها بما يلوح له من رأي، وافق فيه أو خالف، ولكنه لا يجيز لعلماء العصر المتخصصين، منفردين أو مجتمعين، أن يجتهدوا في رأي يخالف ما ذهب إليه.
فهذا التعصب المقيت الذي يثبت المرء فيه نفسه، وينفي كل من عداه، هو الذي نراه من دلائل التطرف حقاً، فالمتطرف كأنما يقول لك: من حقي أن أتكلم.. ومن واجبك أن تسمع.. ومن حقي أن أقود.. ومن واجبك أن تتبع.. رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ لا يحتمل الصواب.. وبهذا لا يمكن أن يلتقي بغيره أبداً، لأن اللقاء يمكن ويسهل في منتصف الطريق ووسطه، وهو لا يعرف الوسط ولا يعترف به، فهو مع الناس كالمشرق والمغرب، لا تقترب من أحدهما إلا بمقدار ما تبتعد من الآخر.
ويزداد الأمر خطورة حين يـُراد فرض الرأي على الآخرين بالعصا الغليظة، والعصا الغليظة هنا قد لا تكون من حديد ولا خشب، فهناك الاتهام بالابتداع أو الاستهتار بالدين، أو الكفر والمروق - والعياذ بالله - وهذا الإرهاب الفكري أشد تخويفاً وتهديداً من الإرهاب الحسي.
2 - من مظاهر التطرف ولوازمه: سوء الظن بالآخرين، والنظر إليهم من خلال منظار أسود، يخفي حسناتهم، على حين يضخم سيئاتهم. الأصل عند المتطرف هو الاتهام.
وقد كان بعض السلف يقول: إنّي لألتمس لأخي المعاذير من عذر إلى سبعين ثم أقول: لعلّ له عذراً آخر لا أعرفه!
من خالف هؤلاء في رأي أو سلوك - تبعاً لوجهة نظر عنده - اتهم في دينه بالمعصية أو الابتداع أو احتقار السنة، أو ما شاء لهم سوء الظن.
فإذا خالفتهم في سنية حمل العصا، أو الأكل على الأرض مثلاً، اتهموك بأنك لا تحترم السنة، أو لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم !
فإذا أفتى فقيه بفتوى فيها تيسير على خلق الله، ورفع الحرج عنهم، فهو في نظرهم متهاون بالدين.
وإذا عرض داعية الإسلام عرضاً يلائم ذوق العصر، متكلماً بلسان أهل زمانه ليبين لهم، فهو متهم بالهزيمة النفسية أمام الغرب وحضارة الغرب.. وهكذا.
إن ولع هؤلاء المتطرفين بالهدم لا بالبناء ولعٌ قديم، وغرامهم بانتقاد غيرهم وتزكية أنفسهم شنشنة معروفة، والله تعالى يقول: ((فلا تُزكُّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى )) [النجم:32 ].
إن آفة هؤلاء هي: سوء الظن المتغلغل في أعماق نفوسهم، ولو رجعوا إلى القرآن والسنة لوجدوا فيهما ما يغرس في نفس المسلم حسن الظن بعباد الله.
وأصل سوء الظن هو: الغرور بالنفس، والازدراء للغير، ومن هنا كانت أول معصية الله في العالم: معصية إبليس، وأساسها: الغرور والكبر ((أنا خيرٌ مِنه )).
والإعجاب بالنفس أحد المهلكات الأخلاقية التي سماها علماؤنا: معاصي القلوب التي حذّر منها الحديث النبوي بقوله: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه .
الســـقوط في هاويـــة التــكفير
3 ـ ويبلغ هذا التطرف غايته، حين يُسقط عصمة الآخرين، ويستبيح دماءهم وأموالهم، ولا يرى لهم حرمة ولا ذمة، وذلك إنما يكون حين يخوض لجّة التكفير، واتهام جمهور الناس بالخروج من الإسلام، أو عدم الدخول فيه أصلاً، كما هي دعوى بعضهم، وهذا يمثل قمة التطرف الذي يجعل صاحبه في واد، وسائر الأمة في واد آخر.
وهذا ما وقع فيه الخوارج في فجر الإسلام، والذين كانوا من أشد الناس تمسكاً بالشعائر التعبدية، صياماً وقياماً وتلاوة قرآن، ولكنهم أتوا من فساد الفكر، لا من فساد الضمير.
زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهو يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ومن ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم ومع هذا قال عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ووصف صلتهم بالقرآن فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وذكر علامتهم المميزة بأنهم يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان .
هذه العلامة الأخيرة هي التي جعلت أحد العلماء، حين وقع مرّة في يد بعض الخوارج، فسألوه عن هويته، فقال: مشرك مستجير، يريد أن يسمع كلام الله .
وهنا قالوا له: حق علينا أن نجيرك، ونبلغك مأمنك، وتلوا قول الله تعالى: ((وإن أحدٌ مِن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلِغه مأمنه )) [التوبة:6 ]، بهذه الكلمات نجا مشرك مستجير ، ولو قال لهم: مسلم: لقطعوا رأسه !
وما وقع لطائفة الخوارج قديماً، وقع لأخلافهم حديثاً، وأعني بهم من سموهم جماعة التكفير والهجرة .
فهم يكفرون كل من ارتكب معصية وأصر عليها، ولم يتب منها. وهم يكفرون الحكام، لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله.
ويكفرون المحكومين، لأنهم رضوا بهم، وتابعوهم على الحكم بغير ما أنزل الله.
وهم يكفرون علماء الدين وغيرهم، لأنهم لم يكفروا الحكام والمحكومين، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر.
وهم يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم، فلم يقبله، ولم يدخل فيما دخلوا فيه.
ويكفرون كل من قبل فكرهم، ولم يدخل في جماعتهم ويبايع إمامهم.
ومن بايع إمامهم ودخل في جماعتهم، ثم تراءى له - لسبب أو لآخر - أن يتركها، فهو مرتد حلال الدم.
وكل الجماعات الإسلامية الأخرى إذا بلغتها دعوتهم ولم تحلّ نفسها لتبايع إمامهم فهي كافرة مارقة.
وكل من أخذ بأقوال الأئمة، أو بالإجماع أو القياس أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان ونحوها، فهو مشرك كافر.
والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري، كلها عصور كفر وجاهلية، لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله! (انظر كتاب ذكرياتي مع جماعة المسلمين ـ التكفير والهجرة ـ عبد الرحمن أبو الخير ).
وهكذا أسرف هؤلاء في التكفير، فكفروا الناس أحياءً وأمواتاً بالجملة، هذا مع أن تكفير المسلم أمر خطير، يترتب عليه حل دمه وماله، والتفريق بينه وبين زوجه وولده، وقطع ما بينه وبين المسلمين ، فلا يرث ولا يورث و لايوالي، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن،ولا يصلى عليه،ولا يدفن في مقابر المسلمين.
ولهذا حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من الاتهام بالكفر، فشدد التحذير، ففي الحديث الصحيح: من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما فما لم يكن الآخر كافراً بيقين، فسترد التهمة على من قالها، ويبوء بها، وفي هذا خطر جسيم.
وقد صح من حديث أسامة بن زيد: أن من قال: لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام وعَصَمَتْ دمَهُ ومَالَهُ، وإن قالها خوفاً أو تعوذاً من السيف، فحسابه على الله، ولنا الظاهر، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار على أسامة حين قتل الرجل في المعركة بعد أن نطق بالشهادة، وقال: قتلته بعد أن قال: لا إله إلاّ الله؟ قال: إنما قالها تعوذاً من السيف؟ قال: هلاّ شققت قلبه؟ ما تصنع بـ لا إله إلاّ الله ؟!! قال أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ فقط .
ومن دخل الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلاّ بيقين مثله، فاليقين لا يزول بالشك، والمعاصي لا تخرج المسلم من الإسلام، حتى الكبائر منها. كالقتل، والزنى، وشرب الخمر. ما لم يستخف بحكم الله فيها، أو يرده ويرفضه.
4-ضعف البصيرة بحقيقة الدين
لا ريب أن من الأسباب الأساسية لهذا الغلو، هو ضعف البصيرة بحقيقة الدين، وقلة البضاعة في فقهه، والتعمق في معرفة أسراره، والوصول إلى فهم مقاصده، واستشفاف روحه.
ولا أعني بهذا السبب: الجهل المطلق بالدين، فهذا في العادة لا يفضي إلى غلو وتطرف، بل إلى نقيضه، وهو الانحلال والتسيب، إنما أعني به: نصف العلم، الذي يظن صاحبه به أنه دخل في زمرة العالِمين، وهو يجهل الكثير والكثير، فهو يعرف نتفاً من العلم من هنا وهناك وهنالك، غير متماسكة، ولا مترابطة.
ورحم الله الإمام أبا إسحاق الشاطبي، فقد نبه على هذه الحقيقة بوضوح في كتابه الفريد (الاعتصام:2/173 ) فقد جعل أول أسباب الابتداع والاختلاف المذموم المؤدي إلى تفرق الأمة شيعاً، وجعل بأسها بينها شديداً: أن يعتقد الإنسان في نفسه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين، وهو لم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأياً، وخلافه خلافاً.
والحق أن نصف العلم ـ مع العجب والغرور ـ يضر أكثر من الجهل الكلي مع الاعتراف، لأن هذا جهل بسيط، وذلك جهل مركب، وهو جهل من لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري,ولهذا مظاهر عديدة عند هؤلاء، نذكر أهمها فيما يلي:
الاتجاه الظاهري في فهم النصوص الدينية
ولا عجب أن رأينا كثيراً من هؤلاء يتمسكون بحرفية النصوص دون تغلغل إلى فهم فحواها ومعرفة مقاصدها، فهم في الحقيقة يعيدون المدرسة الظاهرية من جديد، بعد أن فرغت منها الأمة، وهي المدرسة التي ترفض التعليل للأحكام، وتنكر القياس تبعاً لذلك، وترى أن الشريعة تفرق بين المتماثلين، وتجمع بين المختلفين.
وهذه الظاهرية الحديثة تتبع المدرسة القديمة في إغفالها للعلل، وإهمالها الالتفات إلى المقاصد والمصالح، وتنظم العادات والعبادات في سِلْك واحد، بحيث يؤخذ كل منهما بالتسليم والامتثال، دون بحث عن العلة الباطنة وراء الحكم الظاهر. وكل الفرق بين القدامى والجدد، أن أولئك أعلنوا عن منهجهم بصراحة، ودافعوا عنه بقوة، والتزموه بلا تحرج، أما هؤلاء فلا يسلّمون بظاهريتهم، على أنهم لم يأخذوا من الظاهرية إلا جانبها السلبي فقط، وهو رفض التعليل مطلقاً، والالتفات إلى المقاصد والأسرار.
تأمل معي هذه النصوص الشريفة:
أ- روى مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار أو أرض العدو.
والناظر في علة هذا المنع يتبين له أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم ينه عن ذلك إلا مخافة أن يستهين به الكفار أو ينالوه بسوء.
فإذا أمن المسلمون ذلك، فلهم أن يصطحبوا المصاحف في أسفارهم إلى غير بلاد الإسلام، بلا حرج، وهذا ما يجري عليه العمل من كافة المسلمين اليوم دون نكير، بل إن أصحاب الديانات المختلفة في عصرنا، ليتنافسون في تسهيل وصول كتبهم المقدسة إلى شتى أنحاء العالم، تعميماً للتعريف بدينهم والدعوة إليه. ويحاول المسلمون أن يلجوا هذا المولج عن طريق ترجمة معاني القرآن حيث لسان الأقوام غير لساننا.
ب- ونص آخر، وهو ما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم.
والناظر في علة النهي يراها ماثلة في الخوف على المرأة من أخطار الطريق، إذا سافرت وحدها في الفيافي والقفار، ولم يكن معها رجل يحميها، ممن يؤتمن عليها، ولا يمكن أن تتعرض لها الألسنة بالقيل والقال، وهذا لا يكون إلا الزوج أو المحرم.
فإذا نظرنا إلى السفر في عصرنا وتغير أدواته ووسائله، وجدنا مثل الطائرات التي تسع المئات، وتنقل الإنسان من قطر إلى قطر في ساعات قليلة، فلم يعد هناك إذن مجال للخوف على المرأة إذا ودّعها محرم في مطار السفر، واستقبلها محرم في مطار الوصول، وركبت مع رفقة مأمونة ؛ وهذا ما قرره كثير من الفقهاء في شأن سفر المرأة للحج، فأجازوا لها أن تسافر للحج مع نسوة ثقات، بل مع امرأة واحدة ثقة، أو بدون نساء ولكن مع رفقه تؤتمن عليها.
الاشتغال بالمعارك الجانبية عن القضايا الكبرى
ومن دلائل عدم الرسوخ في العلم، ومن مظاهر ضعف البصيرة بالدين: اشتغال عدد من هؤلاء بكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية، عن القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرها، فنرى كثيراً منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية أو الأخذ منها أو إسبال الثياب، أو تحريك الإصبع في التشهد، أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل التي طال فيها الجدال، وكثر فيها القيل والقال.
هذا في الوقت الذي تزحف فيه الصهيونية إلينا وتعمل الفرق المنشقة عملها في جسم الأمة الكبرى، وفي نفس الوقت يذبح ويضطهد المسلمون في أنحاء متفرقة من الأرض.
والعجيب أني وجدت الذين هاجروا أو سافروا إلى ما وراء البحار في أمريكا وكندا وأوروبا، لطلب العلم أو طلب الرزق، قد نقلوا هذه المعارك الجانبية معهم إلى هناك.
وكثيراً ما رأيت بعيني، وسمعت بأذني، آثار هذا الجدل العنيف، وهذا الانقسام المخيف بين فئات المسلمين، حول تلك المسائل التي أشرنا إلى بعضها وما يشبهها من قضايا اجتهادية ستظل المذاهب والآراء تختلف فيها، وهيهات أن يتفق الناس عليها.
وكان الأولى بهؤلاء أن يصرفوا جهودهم إلى ما يحفظ على المسلمين وناشئتهم أصل عقيدتهم، ويربطهم بأداء الفرائض، ويجنبهم اقتراف الكبائر.
ومن المؤسف حقاً أن من هؤلاء الذين يثيرون الجدل في هذه المسائل الجزئية وينفخون في جمرها باستمرار، هم أكثر الناس تفريطاً في واجبات أساسية مثل: بر الوالدين، أو تحري الحلال، أو أداء العمل بإتقان، أو رعاية حق الزوجة، أو حق الأولاد، أو حق الجوار، ولكنهم غضوا الطرف عن هذا كله، وسبحوا بل غرقوا في دوامة الجدل الذي أصبح لهم هواية ولذة، وانتهى بهم إلى اللدد في الخصومة والمماراة المذمومة.
ويذكرني هذا بما رواه لي بعض الإخوة في أمريكا عن أحد الذين ارتفعت أصواتهم بالإنكار على المسلمين أكل اللحوم المذبوحة من طعام أهل الكتاب، مما أفتى بحله عدد من العلماء قديماً وحديثاً، وكان هذا من أعلاهم صوتاً، وأكثرهم تشدداً
ومثل هذا الموقف المتشدد والوسوسة في التوافه ـ هو ما أثار الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث سأله مَنْ سأله مِنْ أهل العراق عن دم البعوض ونحوه بعد قتل السبط الشهيد سيد الشباب: الحسين بن علي رضي الله عنهما.
فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن أبي نعم قال:
جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس، فسأله عن دم البعوض؟ - وفي طريق أخرى للحديث أنه سأله عن محرم قتل ذبابا ً - فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: ها! انظروا إلى هذا، يسأل عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني الحسين رضي الله عنه ) وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا (أخرجه أحمد، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح ).
5-الإســـــراف في التحــــريم
ومن دلائل هذه الضحالة: الميل دائماً إلى التضييق والتشديد والإسراف في القول بالتحريم، وتوسيع دائرة المحرمات، رغم تحذير القرآن والسنة والسلف من ذلك.
وحسبنا قوله تعالى: ((ولا تقولوا لِما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ، لِتفتروا على الله الكذِب إنّ الذين يفترون على الله الكذِب لا يُفلِحون )) [النحل:116 ].
وكان السلف لا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزماً، فإذا لم يجزم بتحريمه قالوا: نكره كذا، أو لا نراه، أو نحو ذلك من العبارات، ولا يصرحون بالتحريم، أما الميالون إلى الغلو، فهم يسارعون إلى التحريم دون تحفظ.
فإذا كان في الفقه رأيان: أحدهما يقول بالإباحة والآخر بالكراهة، أخذوا بالكراهة، وإن كان أحدهما بالكراهة، والآخر بالتحريم، جنحوا إلى التحريم.
وإذا كان هناك رأيان: أحدهما ميسر، والآخر مشدد، فهم دائماً مع التشديد، مع التضييق، هم دائماً مع شدائد ابن عمر، ولم يقفوا يوماً مع رخص ابن عباس، وكثيراً ما يكون ذلك لجهلهم بالوجهة الأخرى، التي تحمل الترخيص والتيسير.
*ومثل ذلك قضية تقصير الثوب الذي التزمه كثير من الشباب المتدين، رغم ما جر عليهم من متاعب أسرية واجتماعية، بدعوى أن لبس الثوب إذا زاد عن الكعبين، فهو حرام، وحجتهم الحديث الصحيح؛ ما أسفل من الكعبين فهو في النار والأحاديث التي جاءت بالوعيد الشديد لمن يسبل إزاره، ومن يجر ثوبه.
ولكن هذه الأحاديث المطلقة قد قيدتها أحاديث أخر، حصرت هذا الوعيد فيمن فعل ذلك على سبيل الفخر والخيلاء، والله لا يحب كل مختال فخور.
نقرأ في حديث ابن عمر في الصحيح : من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وحديثه الآخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة ، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة (رواهما مسلم ).


 إدارة المنتدى قامت بإفتتاح شريط الإهداء وكذا شريط الإعلان
إدارة المنتدى قامت بإفتتاح شريط الإهداء وكذا شريط الإعلان
 بإمكان الأعضاء إرسال إهداءاتهم و إعلاناتهم وذلك بإرسال رسالة خاصة إلى Melouza_Info
بإمكان الأعضاء إرسال إهداءاتهم و إعلاناتهم وذلك بإرسال رسالة خاصة إلى Melouza_Info
 وهي علبة رسائل المنتدى ليتم عرضها مباشرة على الشريط المتحرك
وهي علبة رسائل المنتدى ليتم عرضها مباشرة على الشريط المتحرك

 العندليب الأسمر: السلام عليكم أحبتي أينما كنتم، أسعد بتواصلي معكم من خلال هذا الإهداء اشتقت لكم جميعا حبا في الله، ويؤسفني الفراغ الذي آل إليه المنتدى، أين أنتم من مسؤولين ومشرفين وأعضاء، أتمنى أن ترجع روح الحوار والنقاش على منتدانا الغالي ولكم مني ألف تحية وسلام
العندليب الأسمر: السلام عليكم أحبتي أينما كنتم، أسعد بتواصلي معكم من خلال هذا الإهداء اشتقت لكم جميعا حبا في الله، ويؤسفني الفراغ الذي آل إليه المنتدى، أين أنتم من مسؤولين ومشرفين وأعضاء، أتمنى أن ترجع روح الحوار والنقاش على منتدانا الغالي ولكم مني ألف تحية وسلام  فراشة الجزائر: بمناسبة خطوبة الأخ الكريم على قلوبنا (خوجة الصغير) أتقدم أنا وكل من يعرفه بأحر التهاني وأطيب الأماني متمنين له حياة زوجية سعيدة. وعقبال الذريية. فألف ألف مبروك ياصغير أنت وخطيبتك.
فراشة الجزائر: بمناسبة خطوبة الأخ الكريم على قلوبنا (خوجة الصغير) أتقدم أنا وكل من يعرفه بأحر التهاني وأطيب الأماني متمنين له حياة زوجية سعيدة. وعقبال الذريية. فألف ألف مبروك ياصغير أنت وخطيبتك.  فراشة الجزائر : إهداء من فراشة الجزائر (ياسمين) إلى كل أعضاء هذا المنتدى، وبالخصوص إلى المشاكس.
فراشة الجزائر : إهداء من فراشة الجزائر (ياسمين) إلى كل أعضاء هذا المنتدى، وبالخصوص إلى المشاكس.  إسلام/ع.النور/وحيد: بمناسبة خطوبة الأخ العزيز على قلوبنا (فاتح معيوف)، نتمنى له حياة زوجية سعيدة وعقبال القفص الذهبي إن شاء لله.
إسلام/ع.النور/وحيد: بمناسبة خطوبة الأخ العزيز على قلوبنا (فاتح معيوف)، نتمنى له حياة زوجية سعيدة وعقبال القفص الذهبي إن شاء لله.  العندليب الأسمر: إلى كل الأحبة بالمنتدى سلام خاص وخاص جدا كلا بإسمه بمناسبة عيد الفطر المبارك 2012 أتقدم للجميع بأحر التهاني وأطيب الأماني راجيا من المولى عز وجل أن يغفر لنا وأن يعيد علينا رمضان أعوام عديدة يارب
العندليب الأسمر: إلى كل الأحبة بالمنتدى سلام خاص وخاص جدا كلا بإسمه بمناسبة عيد الفطر المبارك 2012 أتقدم للجميع بأحر التهاني وأطيب الأماني راجيا من المولى عز وجل أن يغفر لنا وأن يعيد علينا رمضان أعوام عديدة يارب  رياض، فارس، حمزة، لمين، حمزة، وليد: نتقدم بأحلى التبريكات للأخ طرشي عبد الكريم بمناسبة دخوله القفص الذهبي راجين من المولى عز وجل مزيدا من السعادة والعقوبة لـ: دزينة ذر ودزينة بنات.
رياض، فارس، حمزة، لمين، حمزة، وليد: نتقدم بأحلى التبريكات للأخ طرشي عبد الكريم بمناسبة دخوله القفص الذهبي راجين من المولى عز وجل مزيدا من السعادة والعقوبة لـ: دزينة ذر ودزينة بنات.  نورس: بأطيب التهاني وأسمى المعاني أبارك لكل الناجحين في شهادة البكالوريا وأتمنى حضا موفقا لأصدقائنا الذين لم يحالفهم الحظ
نورس: بأطيب التهاني وأسمى المعاني أبارك لكل الناجحين في شهادة البكالوريا وأتمنى حضا موفقا لأصدقائنا الذين لم يحالفهم الحظ  جندع: بمناسبة خطوبة الأخ الكريم "قسمية مصطفى" أتقدم أنا وكل أصدقائي له بأحر التهاني وأطيب الأماني متمنين له حياة زوجية سعيدة، فألـــــــــــــف مبروك
جندع: بمناسبة خطوبة الأخ الكريم "قسمية مصطفى" أتقدم أنا وكل أصدقائي له بأحر التهاني وأطيب الأماني متمنين له حياة زوجية سعيدة، فألـــــــــــــف مبروك  ع.النور/إسلام/وحيد: بمناسبة دخول الصديق والأخ (طرشي كريم) القفص الذهبي، نتقدم له بأحر التهاني، لإكماله نصف دينه فألف ألف مبروك والعاقبة للذرية الصالحة إن شاء الله.
ع.النور/إسلام/وحيد: بمناسبة دخول الصديق والأخ (طرشي كريم) القفص الذهبي، نتقدم له بأحر التهاني، لإكماله نصف دينه فألف ألف مبروك والعاقبة للذرية الصالحة إن شاء الله.  Nsoumer: بمناسبة خطوبة الأخ العزيز على قلوبنا (قسمية مصطفى)، أتمنى حياة زوجية سعيدة مع من اختارها شريكة حياته ولعقوبة للذرية الصالحة إن شاء لله.
Nsoumer: بمناسبة خطوبة الأخ العزيز على قلوبنا (قسمية مصطفى)، أتمنى حياة زوجية سعيدة مع من اختارها شريكة حياته ولعقوبة للذرية الصالحة إن شاء لله. 














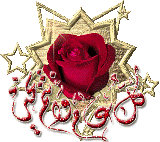



 موضوع: التطرف الديني
موضوع: التطرف الديني 


